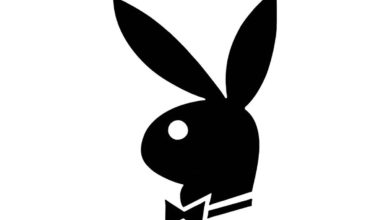نيويورك تايمز: موجز تاريخ الأخبار المزيفة
نيويورك تايمز: الأخبار المزيفة لم تعد “الرسمية” فقط
ترجمة: محمد الصباغ
سنة 1920، نشرت صحيفة ذا ديربورن، التي يمتلكها رجل الصناعة هنري فورد، سلسلة من الموضوعات حول المؤامرة اليهودية العالمية ارتكازًا إلى “بروتوكولات حكماء صهيون،” الوثائق المزيفة التي تعود أصولها إلى روسيا إبان حكم القياصرة، ونشرت عشرات الصحف هذا التزوير كأخبار.
وفي عام 1924، قبل الانتخابات العامة، نشرت دايلي ميل البريطانية خطاب “زينوفييف” المزيف، وزعم أن موسكو أرسلته إلى الشيوعيين البريطانيين لحشد “القوى المتعاطفة” في حزب العمال، وخسر الحزب الانتخابات بنتيجة ساحقة.
في الستينيات، دبر مكتب التحقيقات الفيدرالية تحت قيادة إدجار هوفر، حملة لتشويه مارتن لوثر كينج جونيور. وبجانب خلق قصص ونشرها في الصحافة، زيفت التحقيقات الفيدرالية خطاب تهديد لإظهاره كشخص فاسد، وفي ما يبدو لدفعه نحو الانتحار.
وخلال عام 1987، لقي 96 مشجعًا لفريق ليفربول لكرة القدم مصرعهم في استاد هيلزبروه، بمدينة شيفلد في بريطانيا، بعد تدافع واختناق حتى الموت داخل مدرج مكتظ بأعداد تقوق استيعابه. حينها تغذت الصحف البريطانية على أكاذيب الشرطة، وكتبت أن المشجعين السكارى مسؤولون عن الكارثة.
وفي 2003، في الفترة التي سبقت حرب العراق، امتلأت صفحات الجرائد حول العالم بأخبار عن أسلحة صدام حسين، غير الموجودة، للدمار الشامل.
الأكاذيب التي تتخفى تحت اسم الأخبار هي قديمة على قدر قدم الأخبار نفسها. تاريخ يجب أن نضعه بالحسبان وسط الذعر الحالي بسبب “الأخبار المزيفة”. انتصار دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية جعل الانتباه يتركز على سيل الأخبار الكاذبة، وخصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يعتقد الكثيرون أنها لعبت دورا كبيرا في انتصاره. لكن كثيرون خلال النقاش حول الأمر يتجاهلون التاريخ الطويل من الأخبار المزيفة ويفشلون في إدراك يميز بالفعل السياسة المعاصرة.

في الماضي، تلاعبت الحكومات والمؤسسات الكبرى والصحف بالأخبار والمعلومات. واليوم، أي شخص بحساب على فيسبوك يمكنه فعل ذلك. بدلًا من التنظيم الحريص للأخبار الكاذبة كما في الماضي، هناك حاليًا تدفق فوضوي للأكاذيب. ما تغير ليس تزييف الأخبار، لكن أن المتحكمين في الأخبار فقدوا سلطتهم. كما خسرت مؤسسات النخبة سطوتها على النظام الانتخابي، لذلك تآكلت أيضًا قدرتهم على تحديد ما ليس خبرًا.
الذعر من الأخبار الكاذبة غذى فكرة أننا نعيش في عصر “ما بعد الحقيقة”. جعل قاموس أكسفورد هذه الكلمة “post-truth” كلمة العام، وعرفها بأنها “الظروف التي تكون فيها الحقائق أقل تأثيرا في تشكيل الرأي العام من مناشدة العاطفة والمعتقدات الشخصية.” لكن كما الوضع مع الأخبار المزيفة، الحقيقة، لو ما زلنا نستخدم هذه الكلمة، حول “ما بعد الحقيقة” أكثر تعقيدًا مما يسمح الكثيرون به.
اعتمدت السياسة دائما على ما هو أكثر من الحقائق في ما يخص العالم، كما تضع إطارا أيديولوجيا من خلاله يتم تفسير الحقائق. لننظر مثلًا إلى بعض أهم الأسئلة التي هيمنت خلال بدايات ترشح ترامب. هل سيكون هناك تسجيل للمسلمين؟ هل سيرحل كل العاملين الذين لا يحملون وثائق؟ هل التعذيب مقبول؟ هل سيجرم الإجهاض؟
أعارض أن يتم تسجيل بيانات المسلمين، وأعارض التعذيب، وأدين عمليات الترحيل الجماعي، وأدعم حقوق الإجهاض. أفعل ذلك وليس ببساطة بسبب الحقائق القائمة على التجريب، لكن لأن هناك معتقدات سياسية ونفسية أحملها وهي أقوى من الحقائق، الإيمان بالحقوق والقيم هو ما يجب أن يكون عليه الإنسان. لو أظهرت الحقائق أن التعذيب حقق نتائج، سأظل على معارضتي له. وحقيقة أن التقدم الطبي جعل من الممكن الإبقاء على الجنين في فترة مبكرة حيًا خارج الرحم، لا يغير وجهة نظري بشأن الإجهاض.
ولا يعني ذلك أن العاطفة تقودني أكثر من الواقع. بل إنه حينما يتعلق الأمر بالسياسة، تكون للحقيقة منطقية فقط عندما تكون في إطار أيديولوجي.
في الماضي، صنعت هذه الأطر كنتيجة للانقسام السياسي بين اليسار واليمين. يحمل كل منهما رؤية أيديولوجية مختلفة نحو العالم، ويفسرون الحقيقة ذاتها بشكل مختلف وينتهون إلى استنتاجات مختلفة حول السياسات.
أما الآن، فهذه الأطر تجزأت وتشكلت بشكل أكبر عن طريق الهوية وليس الأيديولوجية. الخط الفاصل الرئيسي حاليًا ليس بين اليسار واليمين بل بين من يرحبون أكثر بالعولمة والتكنوقراطية، وبين هؤلاء ممن يشعرون بلا صوت ومستبعدين ومحرومين.
مناصرو ترامب ومنتقدوه من الليبراليين، كانوا على جانبين مختلفين من هذا الانقسام الجديد. رأى كثير من أنصاره وضعهم الاقتصادي الهش وصمتهم السياسي نتيجة للعولمة والهجرة. بينما يرى الليبراليون هؤلاء المصوتين كمجموعة من البائسين. كل جانب يفسر الحقائق والأخبار وفقًا لأطره الثقافية والسياسية الخاصة.
أدى ذلك إلى نقاشات صادمة حول أشخاص يعيشون في غرف ليس بها سوى صدى صوتهم، وفي عزلة عن العالم الاجتماعي، وفيها وجهات النظر التي يسمعونها فقط هي صدى أصواتهم فقط. ونقاشات أيضًا حول دور وسال التواصل الاجتماعي في خلق هذه العوالم. تشير الدراسات إلى أن مثل هذه المخاوف مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال، يمتلك مستخدمو فيسبوك وسيلة للوصول إلى آراء عكسية.
والأكثر أهمية هو أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تخلق عالمًا ممزقا. بل فقط عكست وأوضحت ما هو موجود بالفعل، عالم فيه تآكلت سلطات المؤسسات التقليدية، وفيه اختفت الطرق القديمة للتغيير السياسي، وفيه عادة قدرة على الغضب دون استخدام مطبوعة سياسية تقليدية.
لو أن مشكلة الأخبار المزيفة أكثر تعقيدًا من المشار إليه، فعادة ستكون الحلول المقترحة أسوأ من المشكلة نفسها. هناك مطالبات لفيسبوك بمراقبة انتشار الأخبار ومنع المزيفة، وللقانون بفرض عقوبات قاسية على من يروج الأكاذيب. لكن من سيقرر ما هو الكاذب وما الذي ليس كذلك؟
هل تريدون حقًا من مارك زوكربيرج، أو حكومة الولايات المتحدة الأميركية، أن يحددوا ما الحقيقة؟ هل تريدون حقًا العودة للأيام التي كانت فيها الأخبار المزيفة هي أخبار مزيفة “رسمية”؟
الأخبار المزيفة مشكلة. لكن لا يجب أن نبالغ في حداثتها أو أن لا ندرك بطريقة صحيحة أسبابها أو أن نروج لعلاج هو أسوأ من المرض نفسه.